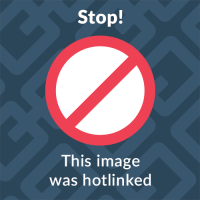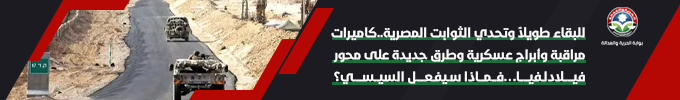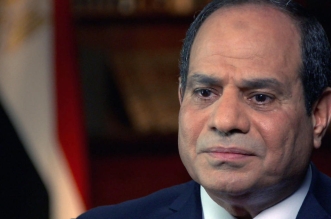في يوم 26 مارس 1979، وقَّع الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني اتفاقية كامب ديفيد برعاية أمريكية؛ لتتحول مصر من دولة منتصرة إلى دولة راضخة للشروط الإسرائيلية، على الرغم من الرفض العربي الكبير وقتها.
ويتوافق ذلك اليوم مع بدء مسرحية انتخابات السيسي، ليستكمل مسار التنازلات لإسرائيل والأمريكان، وليُمكِّن للسيطرة الغربية للمشاريع الصهيو أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي السادس والعشرين من مارس 1979، وعقب انتهاء ما سُمِّي بمحادثات كامب ديفيد، وقَّع الجانبان على المعاهدة التي تضمنت عدة محاور رئيسة هي: إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر والكيان الصهيوني، وانسحاب الصهاينة من سيناء المحتلة عام 1967، كما تضمنت الاتفاقية ضمان عبور سفن العدو من قناة السويس واعتبار مضيق “تيران” وخليج العقبة ممرات مائية دولية. وأشارت الاتفاقية أيضا إلى ضرورة البدء في مفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
ويخلط كثيرون بين اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة، ويبدو أن ذلك يحدث عن جهل؛ لأن اتفاقيتي كامب ديفيد قد جرتا في العام 1978، بينما كانت المعاهدة في مثل هذا اليوم من عام 1979، وكانت الاتفاقية الأولى قد حملت عنوان “إطار السلام في الشرق الأوسط”، بينما حملت الثانية عنوانا آخر هو “إطار الاتفاق لمعاهدة السلام بين البلدين”.

تداعيات الاتفاقية
تصاعدت الاحتجاجات في الوطن العربي على انفراد مصر باتفاقية صلحٍ تعترف فيها بشرعية دولة قامت على أنقاض فلسطين. وأدان مؤتمر القمة في بغداد الاتفاقية، وهدد بقطع العلاقات مع القاهرة، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس. كما أكد قرار القمة العاشر في تونس قرار بغداد بمقاطعة مصر في شهر نوفمبر. ووصف السادات قرار قطع العلاقات مع مصر بأنه “كان تطاولا وقحا منهم- يقصد الدول العربية- فاندفعوا في موكب واحد”. وأضاف أن “عشرات المليارات “نازلة” علينا وبحمد الله من غير الأمة العربية.. مضت السنين العجاف، لأننا عرفنا طريق السلام. مضت كل المعاناة”.
لقد وعد الرئيس السادات الشعب المصري بأنهار اللبن والعسل التي سيغترفون منها بعد توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.. وها نحن نرى اليوم ثمار المعاهدة تتحقق في وضع اقتصادي هو الأخطر على مدى تاريخ مصر الطويل.
كان الهدف هو إخراج مصر من الصراع العربي الصهيوني وهي الركيزة الأساسية في قوة العرب، ليخلو الكيان الصهيوني بالدول العربية، مع استمراره في شن الحرب على مصر بطرق أخرى طالت كل المجالات وفي القلب منها الزراعة المصرية التي تم تدميرها تحت مسمى تبادل الخبرات بين الجانبين.. وكان على رأس القائمة زراعة القطن المصري التي صارت في ذمة التاريخ.
فرصة للصهاينة
أتاحت تلك المعاهدة الفرصة للكيان الصهيوني لوضع خطط تخريبية تطول المنطقة بأسرها، كما أكد ذلك ما اعتبره البعض استراتيجية للصهيونية العالمية في فترة ما بعد المعاهدة التي تضمنت العمل على تفتيت الوطن العربي على أسس دينية.. وعرقية.. ومذهبية باعتبار ذلك التفتيت هو الضمان الوحيد لأمن الكيان.
لقد حققت المعاهدة للكيان الصهيوني كل ما كان يرجوه وأكثر، فتوالت اعتداءاته على الدول العربية، وزاد في تنكيله بالشعب الفلسطيني.. واستمرت عملية تهويد القدس والمقدسات الإسلامية في جميع أرجاء فلسطين، ولم تجن مصر من هذه المعاهدة سوى الاكتواء بنار الإرهاب والعزلة عن محيطها العربي التي استمرت لعشر سنوات.. وما زالت تداعيات ” كامب ديفيد” تتوالى في دمار شامل يمتد عبر دول عربية خرجت فعليا من أوسع أبواب التاريخ إلى غياهب النسيان.
السيسي يعمق الخيانة
وبصورة فجة جاء السيسي ليغوص بمصر أكثر في وحل التطبيع مع الصهاينة، فمنذ أول لحظات انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أعلن عن أن أراضي مصر وظيفتها حماية أمن جارتها إسرائيل، قائلا إنه لن يسمح بأي عدوان من الأراضي المصرية على دول الجوار، وهو ما التزم به تجاه إسرائيل، ونقضه إزاء الشعب الليبي العربي، وتحولت أراضي مصر إلى مركز لانطلاق العدوان العسكري الإماراتي والروسي والسيساوي على ليبيا.
ثم توالت الخيانات التي تمت سرا بين السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في العقبة وفي تل أبيب وفي القاهرة، كما قدمت مصر السيسي اقتراح صفقة القرن لإسرائيل لنقل الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن القدس لأراضي سيناء بتمويل أمريكي.
كما قدم السيسي للصهاينة خدمات مجانية بحصار الفلسطينيين في قطاع غزة، بجانب ضغوط سياسية متوالية لفرض مصالحة بمقتضاها يتم نزع سلاح حركات المقاومة الفلسطينية.
وفي سياق متواصل من الخيانة، صوت السيسي لإسرائيل مرتين بالأمم المتحدة، دون أي إحساس بما تمثله إسرائيل للأمة العربية من مخاطر وتهديدات استراتيجية، بل الأكثر من ذلك هجَّر السيسي أهالي رفح والشيخ زويد وصولا إلى العريش؛ لإخلاء سيناء من سكانها من أجل الصهاينة.