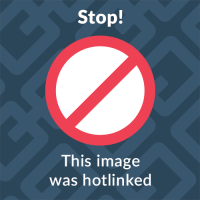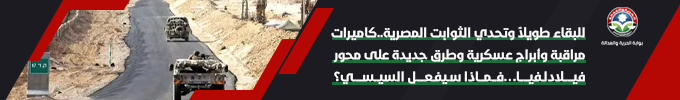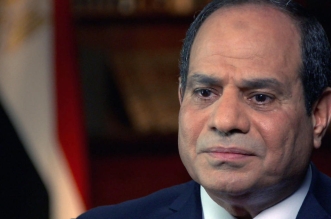تبقى ثورة 25 يناير 2011م هي الحراك الأكثر نبلا ورقيا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ لا يضاهيه في ذلك النبل سوى المقاومة الشعبية في السويس بقيادة الشيخ حافظ سلامة، رحمه الله، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء حرب أكتوبر 1973م، وهي المقاومة التي حالت دون احتلال المحافظة والسيطرة على مقر الجيش الثالث بعد ثغرة الدفر سوار وعبور جيش الاحتلال إلى الضفة الغربية من القناة وحصار السويس. لكن علينا في ذات الوقت أن نفهم كيف تدحرجت الأحداث حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بخلع الرئيس الأسبق حسني مبارك والدخول في مرحلة انتقالية لإقامة نظام ديمقراطي أسفر عن برلمان ورئيس ودستور لكن المؤسسة العسكرية انقلبت على إرادة الشعب الحرة النزيهة، ودبرت انقلابا عسكريا دمويا دمر مصر وثورتها وتجربتها الديمقراطية الوليدة لخدمة مصالح المؤسسة من جهة ومصالح رعاتها في الخارج من جهة أخرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والخليج.
لا جدال في أن حراك الشعب السلمي الذي كان يهتف بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية كان هو الفعل الرئيس الذي أبهر العالم ودفع كل الحكومات الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا وغيرها إلى التعاطف مع الحراك الثوري المصري، هذا الحراك المفاجئ وغير المتوقع بهذه الكثافة التي جرت أجبر نظام مبارك على ردود أفعال عشوائية زادت من الغضب عليه والتعاطف مع الحراك في ميدان التحرير، وكانت بسالة الثوار في موقعة الجمل 2 فبراير 2011م محطة حاسمة في مسار الثورة، ورأت المؤسسة العسكرية في هذه الحراك مصلحة لها؛ لأنه بذلك سوف يقضي على أطماع التوريث لدى جمال مبارك وشلته من حولته؛ ولذلك تلكأت المؤسسة العسكرية في استخدام العنف ضد المتظاهرين بعدما سقط جهاز الشرطة والأمن الوطني في الموجة الثانية للثورة في جمعة الغضب 28 يناير، وهو ما أجبر مبارك على استدعاء الجيش. وكان لخطابات الرئيس الأمريكي باراك أوباما تأثير لا يستهان به في الإطاحة بمبارك والحيلولة دون استخدام المزيد من العنف ضد الحراك في ميدان التحرير، وأمام تزايد الحراك وتطور الأحداث وعجز نظام مبارك؛ رأت المؤسسة العسكرية أن مصالحها مع مبارك باتت في خطر فتمت التضحية به من أجل حماية مصالح المؤسسة في إطار مخطط استهدف الإطاحة بالرأس (مبارك) من أجل إنقاد الجسد (النظام) لحين رسم خطط ومسار يفضي إلى صناعة رأس جديد من داخل النظام نفسه.
هذه العوامل مجتمعة تضافرت لإسقاط مبارك على النحو الذي جرى؛ والدرس الأهم على الإطلاق أنه إذا كان الحراك الشعبي هو الأساس في كل ذلك ولا شك، إلا أنه وحده لم يكن كافيا لإسقاط مبارك؛ فموقف المؤسسة العسكرية كان مرجحا ومؤثرا لأن مصالحها تقاطعت مع شيء من مصالح الحراك وهو الإطاحة بمخططات التوريث. وكذلك كان للموقف الأمريكي والأوروبي الذي أبدى تعاطفا مع الثائرين بميدان التحرير دور في حسم المؤسسة العسكرية خيارها والضغط على مبارك من أجل الخروج من المشهد. هذه هي أضلاع المثلث الذي أدى إلى الإطاحة بمبارك (حراك شعبي قوي وكثيف + موقف دولي متعاطف مع الحراك لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية + موقف مذبذب من المؤسسة العسكرية انحازت في نهايته للحراك خوفا على مصالحها).
إزاء هذه المعطيات فإن قصور الإدراك عند حدود الدعوة إلى الحشد الجماهيري دون إدراك باقي العوامل التي أسهمت في الإطاحة بمبارك لا يمكن أن يحقق الأحلام المنشودة؛ وبالتالي فنحن نحتاج إلى الإجابة عن استفسارات وأسئلة لحوحة بشأن مواقف هذه الأضلاع الثلاثة؛ هل يمكن أن تخرج حشود كثيفة بناء على الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر 2022 بالتزامن مع مؤتمر المناخ الدولي الذي يقيم خلال نفس الفترة بمدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية الأمم المتحدة؟ وإذا خرجت حشود كثيفة فعلا رغم أن ذلك مستبعد وفقا للمعطيات الراهنة وعمليات البطش الأمني المتصلة منذ انقلاب 03 يوليو 2013م، وعدم وجود طليعة ثورية مؤثرة تقود الحشود بفعل الاعتقالات والقتل والهجرة، فما موقف المؤسسة العسكرية؟ وهل يمكن أن تنحاز إلى حراك كهذا وعلى رأسها محمد زكي الذي كان رئيسا للحرس الجمهوري وهو من اختطف الرئيس المنتخب من القصر الجهوري أثناء الانقلاب؟ وهل المؤسسة العسكرية يمكن أن تنقلب على رئيسها وقائدها؟ وإذا كانت هناك أجنحة داخل المؤسسة العسكرية لا ترغب في بقاء السيسي بعدما فشل في إدارة البلاد وخربها وتآكلت شعبيته إلى ما دون الحضيض، فهل هذه محل إجماع داخل المؤسسة أم هي مجرد رغبات لبعض قادتها المؤثرين؟ ومن جهة أخرى ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشأن انقلاب عسكري على السيسي وهو رجلهم الذي يبدي أعلى صور الطاعة الانصياع لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية على نحو مدهش ومثير للإعجاب؟
بالنسبة للضلع الأول، فإن توقع استجابة حاشدة لأي دعوة تظاهر هو محل شك كبير في ظل الأوضاع الراهنة لا سيما في ظل عدم وجود طليعة ثورية تقود الحراك وتحرك الجماهير وتحفزها على الخروج. ورغم ذلك فإن هذا التوقع ليس مطلقا بل هو نسبي، وتوقع عدم الاستجابة الشعبية هو أمر مرجح ولكنه ليس مستبعدا؛ فالمصريون يئنون بشدة تحت وقع الغلاء الفاحش الذي أسقط عشرات الملايين تحت خط الفقر؛ فأسعار الغذاء تنخفض في بلاد العالم وترتفع في مصر بفعل أزمة الدولار الذي ارتفع من 15.7 إلى 19.6 جنيها خلال الشهور الخمس الماضية، ما يعني أن الجنيه انخفض بنسبة تصل إلى 25%؛ ويكفي أن نعلم أن طن الدقيق في مصر أعلى بنحو "2500" جنيه عن السعر العالمي؛ يعني أن سعر الدقيق في مصر أعلى من أسعاره في واشنطن ولندن وباريس رغم الفروق الهائلة في مستويات المعيشة.
أما الضلع الثاني، هو المؤسسة العسكرية، فإن ما تروجه من أنها لا تعرف طريق الانقلابات هو محض افتراء؛ فالجيش قاد انقلاب 3 يوليو 1952م على الحكم الملكي، ومن يومها وهو يحتكر الحكم والسلطة. كما أن الجيش دبر انقلابه المشئوم على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بعد ثورة 25 يناير فنسف الثورة ودمر المسار الديمقراطي. قد يقول قائل: لكن فاروق ومرسي لم يكونا جنرالين من داخل المؤسسة العسكرية رغم أن فاروق تعلم في الكلية الملكية العسكرية البريطانية، وهذا صحيح بمعنى أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تدبر انقلابات ضد المدنيين وغير المحسوبين عليها، لكنها أبدا لا يمكن أن تقود انقلابا على رئيس جنرال من أبنائها. والسيسي هو المؤسسة ودائما ما يتباهى بذلك، وقد كان وزيرا للدفاع حين دبر انقلابه المشئوم الذي دمر مصر وثورتها وديمقراطيتها الوليدة. رأي آخر يرى عكس ذلك؛ ويرى أن المؤسسة العسكرية هو مؤسسة انقلابات بالأساس؛ فهي أصلا تحكم مصر بانقلاب عسكري منذ يوليو 52، كما أن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر اغتال صديقه وزير الدفاع الأسبق عبدالحكيم عامر في إطار الصراع بينهما على السلطة. كما أن هؤلاء يرون أن ما جرى مع مبارك هو بحد ذاته انقلاب، وحسب هؤلاء فرغم أن الحراك في التحرير كان كثيفا إلا أن الجيش هو من أجبر مبارك على الخروج من المشهد وبالتالي فإن الجيش لا يمانع أساسا من تدبير انقلابات على أي رئيس حتى لو كان من أبنائه ما دام ذلك سيحافظ على المؤسسة العسكرية. معنى ذلك أن المؤسسة العسكرية سوف تبقى خلف السيسي لكنه قد تغير موقفها إذا تغيرت المعادلة على الأرض ورأت أن مصالحها مع السيسي قد انتهت وأن بقاءه وحمايته يمثل تهديدا لمصالحها ومصالح رعاتها بالخارج.
ويبقى الضلع الثالث، وهو الموقف الدولي والأمريكي منه على نحو خاص؛ فأثناء ثورة يناير كان أوباما رئيسا وقد كان يتطلع إلى شيء من الديمقراطية انحيازا إلى فريق الشباب داخل البيت الأبيض حينها والذي كان يتبنى الانحياز إلى الثوار في الميدان على عكس فريق العواجيز الذي كان يرى ضرورة حماية مبارك والإبقاء عليه وتبنى رؤية تقوم على تغيير بطيء في أعلى هرم السلطة بمصر تحت رعاية مبارك نفسه والمؤسسة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة وعلى رأسها "إسرائيل"، وكان هذا على رأس هذا الفريق جو بايدن ، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، والسيدة هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية وقتها، معنى ذلك أن توقع دعم أمريكي تحت حكم بايدن لأي ثورة مقبلة هو شيء من الوهم لا تدعمه الحقائق على الأرض. نفس الأمر ينطبق على باقي الحكومات الغربية التي تعلمت الدرس وأن البديل للنظام العسكري في مصر هو الإسلاميون، وهؤلاء غير مرغوب فيهم؛ ولعل هذا يفسر أسباب دعم وتواطؤ الحكومات الغربية للنظم المستبدة في مصر والمنطقة؛ فمصالح هؤلاء مع بقاء هذه النظم وغياب الديمقراطية وتهميش الهوية الإسلامية.
خلاصة الأمر، رغم أن المعطيات على الأرض محبطة إلا أن التنبؤ بما يمكن أن يحدث بشكل مطلق ، غير منطقي ويتصادم حتى مع العقائد والأفكار الإسلامية، وكما أن ثورة يناير فاجأت العالم فلا أحد يدري ما الذي يمكن أن يحدث خلال الأسابيع والشهور المقبلة؛ لأن الوضع في مصر هش للغاية وفوضوي للغاية، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يضغط على النظام ويضغط على المواطنين واحتمال اندلاع احتجاجات أمر كبير الاحتمال، فمصر تنتظر شرارة البدء، وليس بالضرورة في 11 نوفمبر المقبل، قد تكون في أي وقت ولسبب بسيط أو تافه يؤدي إلى اندلاع حريق كبير يوازي الآلام الناتجة عن لهيب الأسعار المرتفعة. النظام من جانبه يدرك ذلك، ورغم قبضته الأمنية الباطشة وجيش الجواسيس والمخبرين في كل مكان إلا أنه مرعوب؛ نعم مرعوب من المستقبل ويخشى المجهول الذي لن يكون في صالحه في كل الأحوال؛ فكل السيناريوهات تؤكد انهيار نظام السيسي حتى لو فشلت الدعوات إلى التظاهر في 11/11.